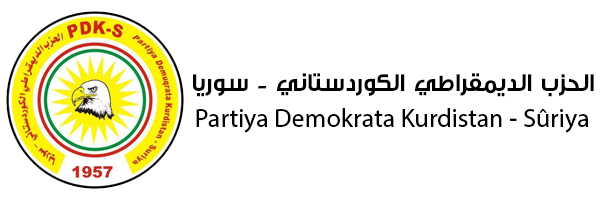النيوعشائرية الكردية في سوريا… بين الضرورة والخطورة
شيروان إبراهيم
اجتماع هيئة للعشيرة، انتخاب مجلس موحّد لعدّة عشائر، ملتقى لأعيان القبيلة، وتلبيس عباءات لبعض المستحقين وغير المستحقين… عناوينُ أخبارٍ تتردّد على ألسنة بعض الكرد السوريين وصفحاتهم في وسائل التواصل خلال السنوات الأخيرة، وقد حَظي بعضها باهتمامٍ إعلامي واسع أيضًا.
ليست هذه العشائرية التقليدية القديمة، بل نمطٌ جديد قد يتناسبُ مع الوقت الراهن. ولهذا — وبالإذن من علماء الاجتماع — لنسمِّها «النيوعشائرية»، تماشيًا مع مصطلحات العصر التكنولوجي.
مفرِطون سابقًا في اليسارية أو العلمانية أو الشيوعية باتوا أيضًا طامحين لمنصبٍ اجتماعي في أحد أفخاذ قبيلتهم أو أذرعها. بعضهم تذكّر فجأةً أنّ جدَّه الثامن كان باشا أو آغا أو شيخًا أو بيكاً… بعد أن كان يَصِف حتى بعض ثورات التحرُّر أنها فاشلة لأنها ذات خلفية عشائرية.
محاولاتٌ حثيثة تظهر لإعادة تشكيل كُتَلٍ اجتماعية: بعضها لغاياتٍ نبيلة، وأخرى لها امتداداتٌ وأطماعٌ شخصية تحت عباءة الوجاهة، أو لخبثٍ سياسي. فما الأسباب؟ وما التأثيرات؟
إنّ التطوّر الاجتماعي بين كرد سوريا منذ أواخر القرن الماضي أزال — رويدًا رويدًا — عاداتٍ عشائرية عديدة، سلبيةً كانت أو حتى إيجابية. فقد لعبت التيارات الشيوعية واليسارية من جهة، والقومية الكردية من جهةٍ أخرى، دورًا في إزالة كثيرٍ من العادات المجتمعية الراسخة قرونًا. لكن، وبموازاة محاربة تلك السلبيات، لم تُضِف التيارات السياسية بدائلَ مجتمعية، بل ما لبثت أن انتقلت من أهدافٍ وطنية جامعة عابرة للروابط العائلية إلى التفرّغ لافتعال الشقاق السياسي.
الانشقاقاتُ التنظيمية والفكرية التي أصابت تلك التّجمّعات السياسية — وبشكلٍ مفرِط — لم تتوقف عند حدود التنظيم المؤسسي، بل وصلت إلى افتعال شرخٍ مجتمعي أيضًا. الصراعُ السياسي في المجتمع الكردي السوري، على الرغم من اتّسامه عمومًا بالسلمية والتحضّر في الاختلاف، لم يخلُ من سلبياتٍ زادت الشرخ: فقد امتنعت عائلاتٌ كردية عن الزواج والمصاهرة مع عائلاتٍ تختلف معها سياسيًا أو تنظيميًا، رغم وجود قواسمَ مشتركة وروابط أسرية. الانشقاقُ السياسي المبالغ فيه، والمتزامن مع ديكتاتورية البعث وشبح الوضع الاقتصادي السيئ، بلغ حدًّا لا يُطاق، ثم جاء اندلاعُ الثورة السورية ووحشيةُ الجيش الأسدي والحروبُ المتفرّعة عنها ليزيد الطين بِلّة. كلّ ذلك يدفع الأفراد إلى الالتفاف حول بعضهم بعضًا، ولما كانت التنظيماتُ الجديدة لم تفِ بالغرض، فمن الطبيعي العودةُ إلى الروابط الأسرية والقروية والمناطقية… في محاولةٍ طبيعية للتكافل.
لذا من الطبيعي أن نعود، ونشهد إحياءَ العشائرية، بل وروابطَ أبناء القرية الواحدة ممن هاجروا منذ عقود. ومن الطبيعي أيضًا أن نرى محاولات «النيوعشائرية» لا تكتفي بالشأن الاجتماعي، بل تسعى — في الآونة الأخيرة — إلى تسييس هذه الروابط، كما هو الحال لدى عشائر عربية كثيرة وانقسامها بين ولاءاتٍ متضادة على الأرض السورية.
الأعرافُ الشرقية التقليدية — ومنها الروابطُ العائلية والعشائرية — ليست سلبيةً بالمطلق كما يُسوِّق البعض بأنها من بقايا عصورٍ غابرة. فالوجهاءُ الاجتماعيون قادرون — في أحيان كثيرة — على الحفاظ على السلم الأهلي أكثر من السلطات، بل، يمكنُهم توجيهُ الجموع إلى «فزعاتٍ» لمساعدة المحتاجين في الطوارئ. وفي المقابل، ليست كلُّ الأعراف التقليدية صالحةً للزمن الحالي كما يروّج آخرون باسم «الأصالة» ويَصِمون الأفكارَ الأخرى بأنها دخيلة أو مؤامرات. وعليه، فإن التفافَ أبناء العشيرة الكردية حول أنفسهم — أو أبناء قريةٍ ما في الداخل أو المهجر — إذا كان بغرض التكافل الاجتماعي والمساعدة فهو أمرٌ محمودٌ وضروريٌّ في هذه المرحلة التي تشهد تقلباتٍ جذريةً، ولا استقرارَ سلطويًّا في عموم الجغرافيا السورية؛ شريطة ألّا تتحوّل هذه الخطوات من ترابطٍ اجتماعي إلى غاياتٍ سياسيةٍ تخدم مصالحَ بعضٍ وتُعادي بعضًا آخر، أو إلى تسويق عاداتٍ بائدة لا تلائم العصر.
الخلاصة: كلُّ محاولةٍ تصبّ في توجيه مجموعةٍ من الناس نحو أهدافٍ سامية وتعزيز التكافُل الاجتماعي والسلم الأهلي والإصلاح الأهلي، تستحقّ الشكرَ والدعم — سواء أكانت على مستوى عشيرة أو قبيلة أو عائلة أو قرية أو حارة — أمّا استخدامُ أيِّ ترابطٍ اجتماعي لأغراضٍ في غير محلها ولتوجُّهاتٍ سياسيةٍ أو تنظيمية، فيستحقّ الوقوفَ في وجهه ونبذه. ولِمَن يتخوّفون من «عودة التخلف» بسبب هذه المحاولات، عليهم أن يعلموا أنّ الزمنَ تغيّر، ولا يمكن إقناعُ الجيل الجديد بالعودة إلى الوراء؛ المطلوبُ فقط الحذرُ من عدم توظيف هذه الروابط في الصراعات السياسية. أمّا اللاهثون وراء إثبات ذواتهم — بسبب عقدِ نقصٍ شخصية — عبر تبنّي ألقابٍ مشيخية، فلا يُقدِّمون، ولا يُؤخِّرون؛ دعوهم يمارسوا حرّيتهم الشخصية. في النهاية، المجتمعُ هو الذي يحدّد مَن الشيخُ ومَن «المُتشيّخ».
( المقال منشور في جريدة كوردستان العدد 761 )